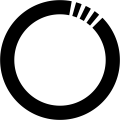الجزء الاول تائه في الكون
“إنهم كلهم في نفس المستوى إنهم يدورون في نفس الاتجاه……..إنه الكمال إنها الروعة. إنها تكاد أن تكون شيئا غريبا” (الفلكي جيوفري ماركي) واصفا المجموعة الشمسية..
الفصل الأول : كيف تبني كونا
مهما بذلت من جهد في المحاولة لن تتصور أبدا كم هو صغير، البروتون. إنه أصغر مما يجب.
البروتون هو جزء ضئيل من الذرة، التي هي بدورها شيء غير محسوس. إن البروتونات صغيرة لدرجة أن قطرة صغيرة من الحبر مثل تلك المتوجة لهذه ال ز ممكن أن تحوي عددا منها يقارب ال 500,000,000,000 (تحتاج تعديل) و هو عدد أكبر بقدر لا يستهان به من عدد الثواني المحتواة في نصف مليون من الأعوام. إذن أقل ما يقال عنها أنها ميكروسكوبية جدا.
تخيل أنه في إمكانك أن تكمش أحد هذه البروتونات لواحد علي البليون من حجمه الطبيعي، أي لحجم صغير جدا لدرجة أن البروتون سيبدو هائلا بالنسبة له. احشر في هذه المساحة الضئيلة جدا جدا عدة جرامات من المادة. رائع. أنت مستعد تماما لأن تبدأ كونا.
أنا طبعا أفترض أنك تريد أن تبني كونا تضخميا ” inflationary ” إذا كنت تفضل أن تبني كونا تقليديا كالذي يميزه إنفجار أعظم “Big Bang” فإنك ستحتاج لمواد إضافية. حقيقة ستضطر لأن تجمع كل شيء موجود حتي آخر ذرة من المادة من هنا وحتي أطراف الكون وتكمشها في حجم صغير جدا لدرجة أنه ليست له أبعاد. و هو ما يعرف بالمفردة ” singularity”.
في أي من الحاليتن استعد لفرقعة قوية جدا. منطقيا، ستحتاج لمكان آمن لتشاهد منه هذا المنظر. للأسف لا يوجد مكان كهذا لأنه خارج المفردة ليس هناك مكان ولا حتي فراغ . عندما يبدأ الكون في التمدد فأنه لا يتسع ليملأ فراغا أكبر منه. الفراغ الوحيد في الكون هو الذي يخلقه تمدد الكون نفسه.
من الطبيعي جدا و لكنه أيضا من الخطأ أن نتصور المفردة علي أنها نقطة حبلى معلقة في فراغ مظلم لا حد له. لكنه لا يوجد فراغ، ولا ظلام. المفردة ليس حولها شيء. ليس هناك مكان تحتله، مكان توجد فيه. لا يمكنك حتي أن تسال كم مر عليها- ما إذا كانت طرأت علي الوجود مؤخرا، مثل الفكرة الجيدة، او أنها كانت هنا منذ الأبد، تنتظر في سكينة اللحظة المناسبة. الوقت لا وجود له, لا يوجد ماضي لتخرج منه. و هكذا من لا شيء، يبدأ كوننا…
في نبضة خاطفة، لحظة من المجد خاطفة بحيث لا تستوعبها كلمات، تصبح للمفردة أبعاد سماوية، فراغ بما يتجاوز التصور. في الثانية الأولي (ثانية سيكرس كونيون”cosmologists ” عديدون مشوارهم لكي يقسموها للحظات تصغر باستمرار) تظهر الجاذبية وكل القوي الاخري التي تحكم الفيزياء. في أقل من دقيقة يتباعد طرفي الكون بمليون بليون ميل، و تزيد بسرعة. توجد حرارة هائلة الآن عشرة بلايين درجة، حرارة كافية لتبدأ التفاعل النووي اللازم لتخليق العناصر الاخف-الهيدروجين والهيليوم بصفة اساسية مع حفنة (حوالي ذرة من كل مائة مليون) من الليثيوم. في ثلاث دقائق تخلق ثمانية وتسعون بالمائة من كل المادة الموجودة والتي ستوجد. لدينا كون. إنه مكان بإمكانيات رائعة، و جميل أيضا. و لم يأخذ هذا أكثر من الوقت اللازم لإعداد شطيرة.
متى وقعت هذه الاحداث، هو أمر حوله بعض النقاش. الكونيون تشادّوا حول ما إذا كانت لحظة الخلق منذ عشر بلايين عام أو ضعف ذلك، أو قيمة وسطية بين القيمتين. الإتفاق العام يتجه نحو رقم يقرب من 13.7 بليون عام، لكن هذه الاشياء تشتهر بصعوبة شديدة في القياس كما سنرى. كل ما يمكن أن نقوله هو أنه في نقطة ما في الماضي السحيق، لأسباب غير معلومة، أتت لحظة يعرفها العلم ك(ممكن أن نقول مثل بدل حرف ال كـ) ز = 0 “t = 0”. و لامست أقدامنا أول الطريق.
طبعا هناك الكثير جدا مما لا نعرفه، و كثير مما نعلم لم يمر على علمنا به وقت طويل. حتي فكرة الانفجار الأعظم هي حديثة نسبيا. الفكرة بدأت تتلاعب في العقول منذ العشرينيات عندما اقترحها عالم-قس بلجيكي هو جورج لاميتر George Lemaitre لكنها لم تصبح فكرة فعالة في مجال الكونيات cosmology حتي منتصف الستينيات، عندما وقع عالمان فلك راديوي radio astronomers علي اكتشاف بالمصادفة.
الفلكيان هما أرنو بنزياس arno penzias و robert wilson. في 1956، كانا يحاولان استخدام هوائي اتصالات كبير مملوك لمعامل بيل bell laboratories في هولمديل، holmdel عندما اعترض جهودهم ضجيج مستمر في الخلفية، هذا الهسيس المنتظم جعل تجاربهم مستحيلة التنفيذ. الضجيج كان لا مصدر واضح له ولا عوامل مؤثرة عليه. كان يأتي من كل نقطة في السماء، صباحا و مسائا، وخلال كل الفصول. لسنة كاملة فعل الفلكيان الشابين كل ما أمكنهما التفكير فيه لكي يحددا مصدر المشكلة وليقضوا عليها. اختبرا كل نظام كهربي، أعادوا بناء المعدات, تفقدوا الدوائر الكهربية والتوصيلات، قاموا بهز الاسلاك، و إزالة الأتربة من على الموصلات. تسلقوا طبق الاستقبال ووضعوا شريط عزل علي كل فتحة ووصلة. صعدوا ثانية للطبق ومعهم مقشات لكي يزيلوا ما أسموه في ورقة بحثية لاحقا، “مادة بيضاء عازلة” وهي مادة تعرف أكثر باسمها الشائع براز الطيرو(تأكد منها). لا شيء مما فعلوه نجح في حل المشكلة أو حتي تبيان سببها.
ما لم يكونا يعرفاه أن فريق من العلماء يرأسه روبرت ديكي robert dicke في جامعة برينستون princeton علي بعد ثلاثون ميلا فقط من معملهم كانوا يعملون علي البحث عما كانا هما يحاولان جاهدين التخلص منه. فريق البحث البرينستويني كان يتبع فكرة اقترحها في الاربعينيات الفيزيائي الروسي الأصل جورج جاماو george gamaw , وهي انك اذا نظرت عميقا في الكون بدرجة كافية فستجد بقايا إشعاع الخلفية الكونية cosmic background radiation المتبقي من الانفجار الأعظم. حسابات جاماو أثبتت أنه بعدما يقطع الإشعاع الفضاء الشاسع ليصل للأرض سيصل في صورة إشعاع ميكروي microwaves. بل إنه كان في ورقة بحثية لاحقة اقترح أداة لاثبات ذلك: وهي “هوائي إرسال معمل بل في هولميد”. للأسف فإن لا بنزياس ولا ويلسون ولا أي من فريق البحث البرينستوني كان قد قرأ ورقة جاماو البحثية الأخيرة تلك.
هذا الضجيج الذي كان بنزياس وويلسون يسمعانه كان بالطبع الضجيج الذي توقعه جاماو. لقد وجدا حافة الكون أو على الأقل حافة الجزء المنظور منه، على بعد 90 بليون تريليون ميل. لقد رأوا أول فوتونات- أقدم ضوء في الكون – إلا أن المسافة والزمن كانا قد حولاه لأشعة ميكروية بالضبط كما توقع جاماو. في كتابه الكون الانتفاخي the inflationary universe , يقدم الان جوث alan guth تشبيها ليوضح لنا قدر هذا الاكتشاف. إذا تخيلنا أن النظر في أعماق
الكون كالنظر من الأسفل من الدور المائة لمبني الامباسر ستيت،(تحتاج تعديل) حيث يمثل الدور المائة اللحظة الحالية ويمثل مستوى الشارع لحظة الإنفجار الأعظم, فإنه في وقت إكتشاف بنزياس وويلسون فان أبعد مجرة مكتشفة كانت عند الدور الستين و أبعد شيء -الكوازارات quasars- كانت عند مستوى الطابق العشرين. بنزياس وويلسون دفعا معرفتنا بالكون المنظور لمسافة نصف بوصة من الرصيف.
بنزياس وويلسون هاتفا ديكي لعله يجد حلا لمشكلتهما. أدرك ديكي علي الفور ماذا وجد الشابين. “حسنا يا شباب لقد سبقنا” هكذا قال ديكي لزملائه ببرينستون وهو يغلق الخط.
بعدها بفترة قصيرة نشرت مجلة علوم فيزياء الفضاء مقالتين: إحداهما كتبها بنزياس وويلسون يصفان تجربتهما مع الهسيس, والأخرى كتبها فريق ديكي يفسر طبيعة هذا الهسيس. بالرغم من أن بنزياس وويلسون لم يكونا يبحثان عن إشعاع الخلفية الكونية، ولم يعرفا ما هو حين وجداه، و لم يصفاه أو يفسرا سبب حدوثه في أي ورقة بحثية، فإنهما حصلا علي جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1978. الفريق البريستوني لم يحصل إلا علي التعاطف. طبقا لكتاب قلوب وحيدة في الكون lonely hearts in the universe فان بنزياس وويلسون لم يفهما أهمية ما وجداه إلا عندما نشر مقال عن إكتشافهما في النيويورك تايمز.
الحقيقة أن التداخل نتيجة إشعاع الخلفية الكونية هو شيء نألفه جميعا. أدر تلفازك لمحطة ليس عليها إرسال، حوالي واحد في المائة من التشويش الذي تراه وتسمعه يمثل بقايا الإنفجار الأعظم. في المرة القادمة التي تشتكي فيها من أنك لا تجد ما تشاهده، تذكر أنك يمكنك أن تشاهد مولد الكون.
علي الرغم من أن الكل يسميه الانفجار الأعظم، فان كتب عديدة تحذرنا من أن نفكر فيه كانفجار بالمعني التقليدي. الأحرى أنه كان مثل تمدد فجائي على يايعاد(تقصد أبعاد؟) شاسعة. إذن ما الذي سببه؟
إحدي التفسيرات أن المفردة هي بقايا كون منهار سابق بأكمله – وأننا مجرد دورة أزلية من الأكوان المتمددة والمنهارة، مثل البالونة في ماكينة التنفس الاصطناعي. آخرون ينسبون الانفجار العظيم لما يعرف بالفراغ الزائف false vacuum أو الحقل الكمي scalar field أو طاقة الفراغ vacuum energy- أي أنه شيء ما أدي لعدم استقرار في اللاشيء الذي سبق الكون. قد يبدو أن الحصول علي شيء من لاشيء هو من الاستحالة, إلا أنه يبدو أن الكون دليل على احتمال حدوث هذا. أو قد يكون الكون مجرد جزء من أكوان أكبر منه – بعضها يمتد في أبعاد مختلفة- وأن الإنفجارات العظمي تحدث طيلة الوقت. أو أن الوقت والمكان كان لهما طبيعة اخر يمغايرة (هل تقصد أخرى مغايرة) تماما لطبيعتهما الآن قبل الإنفجار الأعظم – طبيعة غريبة عنا لدرجة أننا لا نستطيع حتي تخيلها- و أن الانفجار الأعظم هو مرحلة انتقالية، انتقل فيها الكون من شكل لا يمكننا فهمه إلى شكل نستطيع فهمه بالكاد. “هذه أسئلة قريبة جدا من الدين” يقول دكتور اندريه ليند Andrei Linde عالم كونيات في ستانفورد، للنيويورك تايمز في 2001.
نظرية الانفجار الأعظم ليست عن الانفجار نفسه لكنها تصف ما حدث بعده. ليس بعده بوقت طويل. بإجراء الكثير جدا من الحسابات الرياضية وملاحظة ما يجري بدقة في معجلات الجسيمات Particle Accelerators فإن العلماء يعتقدون أنهم يستطيعون أن ينظروا قديما في الزمان حتي 10 مرفوعة للاس – 43 (هذه اشارة سالبة؟) من الثانية بعد لحظة التكون. عندما كان الكون صغيرا لدرجة أنك كنت ستحتاج لمايكروسكوب لتراه. لا يجب أن نتوقف عند كل رقم يمر بنا، لكنه من الأنسب أن نستعرض واحدا من وقت لاخر، فقط لنتذكر مقياسهم العصي عن التصور. 10 مرفوعة لأس -43 هي 0.00000000000000000000000000000000000000000001 او جزء من مليون تريليون تريليون من الثانية.
ملاحظة رياضية: بما أن الأعداد الكبيرة جدا هي صعبة في الكتابة ومستحيلة في القراءة فأن العلماء يستعملون طريقة مختصرة للتعبير عن مضاعفات العشرة كمثال فان 10,000,0000,000 تكتب 10^10 أي عشرة مرفوعة للأس عشرة و 6,500,000 تصبح 6.5 * 10^6 المبدا بسيط جدا.
10 * 10 أو 100 تصبح 10^2; 10 * 10 *10 أو 1000 تصبح 10^3 و هكذا رقم الأس هو عدد الأصفار التي تلحق بالرقم الرئيسي، الأسس السالبة تمثل عدد المنازل بعد العلامة العشرية فمثلا 10^-4 هي 0.0001
معظم ما نعرف، أو ما نعتقد أننا نعرف عن اللحظات الأولي للكون، يعود لنظرية التضخم والتي اقترحها لأول مرة فيزيائي شاب والذي كان آنذاك يعمل في جامعة ستانفورد، وهو ألآن جوث Alan Guth ، ألآن كان في الثانية و الثلاثين, و باعترافه هو نفسه لم يكن قد قام بأي أعمال هامة من قبل. غالبا لم يكن سيفكر في نظريته هذه لو لم يكن قد حضر محاضرة عن الإنفجار العظيم التي ألقاها روبرت ديكي Robert Dicke. المحاضرة دفعت جوث للاهتمام بمجال الكونيات cosmology وخاصة مولد الكون.
النتيجة النهائية لجهود جوث كانت نظرية التضخم، والتي تقرر أنه بعد جزء من اللحظة بعد الانفجار العظيم، مر الكون بطور تضخم فجائي. التضخم الفجائي لم يستمر لأكثر من 10^-30 من الثانية – أي جزء من مليون مليون مليون مليون مليون من الثانية- لكنها غيرت الكون من شيء يمكنك أن تضعه في راحة يدك لشيء أكبر من هذا بـ10,000,000,000,000,000,000,000,000 مرة. نظرية التضخم تفسر التموجات والدوامات التي تجعل كوننا بشكله الحالي ممكنا. بدونها، لن توجد تجمعات المادة وبالتالي لا شموس، فقط سحب غاز وظلام لانهائي.
طبقا لنظرية جوث، بعد واحد من عشرة مليون تريليون تريليون تريليون من الثانية، ظهرت الجاذبية. بعدها بجزء لا يذكر من الثانية انضمت للجاذبية قوي الكهرومغناطيسية والقوي النووية القوية والضعيفة. بعد هذا بلحظة أخري انضم فيضان من الجزيئات الأولية لتلك القوي. من لا شيء علي الاطلاق، فجأة أصبح هناك فيضان من الفوتونات والبروتونات والإلكترونات والنيوترونات والعديد من الأشياء الاخرى. وطبقا لنظرية الإنفجار العظيم القياسية لقد تكون ما بين 10^79 و 10^89 من كل من هذه الجسيمات الاولية. *لاحظ ان 10^ 89 هذه تعني 1 و يلحقه 89 صفرا أي 10000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000 أوووف إن مجرد كتابة هذا الرقم أصابتني بالتعب فتخيل كم الجسيمات المتكون.*
طبعا مثل هذه الأرقام لا يمكن لعقولنا أن تتخيلها. من الكافي أن نعرف أنه في لحظة خاطفة منحنا كونا شاسعا- مائة بليون سنة ضوئية علي الاقل، لكن يحتمل طبقا لنظريات أخرى أن يكون أي حجم آخر أكبر من هذا ربما حتي لا نهائي- و معد بشكل مثالي لتكون النجوم و المجرات ونظم معقدة أخرى.
لو أن الكون كان قد تكون بشكل مختلف ولو بمقدار صغير جدا عما هو عليه الآن-لو كانت الجاذبية أقوي أو أضعف قليلا، لو كان التضخم قد حدث بشكل أسرع أو أبطأ قليلا- فانه من المحتمل أن أيا من العناصر المستقرة التي نتكون منها أنا وأنت والأرض التي نقف عليها لم تكن لتوجد. لو كانت الجاذبية أقوي قليلا لانهار الكون على نفسه كخيمة غير منصوبة جيدا. أما إذا كانت الجاذبية أضعف قليلا مما هي عليه الآن فإن أيا من مكونات الكون لم تكن لتتجمع معا. الكون كان سيظل للأبد خوائا مملا و مبعثرا.
هذا أحد أسباب أن بعض الخبراء يعتقدون بوجود العديد من الانفجارات العظيمة, ربما تريليوينات التريليونات منها، منثورة عبر الأبدية، وأن السبب في أننا موجودون في هذا الكون بالذات هو أن هذا أحد الأكوان التي يمكننا أن نتواجد فيها. يشرح إدوارد بـ . تريون Edward P. Tryon من جامعة كولومبيا هذا قائلا”: بالنسبة لسؤال لماذا حدث هذا، فإني أقدم كإجابة اأن كوننا هو ببساطة أحد تلك الأشياء التي تحدث من زمن لآخر”.
و يضيف الآن جوث Alan Guth:
على الرغم من أن تكون الكون هو شيء ذو احتمال صغير جدا، فان تريون يؤكد علي أن أحدا لم يحصي المحاولات الغير مثمرة.
مارتن ريس Martin Rees, الفلكي الملكي البريطاني, يعتقد أنه هناك العديد من الأكوان، ربما عدد لا نهائي منها، كل منها بخصائص مختلفة، في تباديل مختلفة، و أننا ببساطة نعيش في الكون الذي يتمتع بخصائص تسمح لنا بالعيش فيه. و يطرح مثالا لتقريب الأمر للأذهان بمتجر كبير للملابس: ” إذا كان هناك مخزون كبير من الملابس، فانك لن تدهش من وجود بذلة تناسبك. إذا كان هناك العديد من الأكوان كل منها يحكمه بقيم (التعديل: يحكم بقيم أو يحكمه قيم) مختلفة من الثوابت، فستجد أحدها حيث تكون قيم تلك الثوابت مناسبة لوجودنا. نحن نعيش في هذا الكون.”
وجد رييس أن ستة أرقام بالتحديد تتحكم في كوننا، و أن تغيير أيا من هذه القيم ولو قليلا فإن الاشياء لم تكن كما هي الآن. كمثال، ليوجد الكون كما هو الآن فإن هذا يتطلب تحول الهيدروجين إلى هيليوم بطريقة دقيقية ومنتظمة – بالتحديد بطريقة تحول 7 أجزاء من ألف من كتلة الهيدروجين إلى طاقة. إخفض هذه القيمة قليلا- من 0.007 الي 0.006 في المائة، كمثال- ولا يمكن أن يحدث هذا التحول: بالتالي سيتكون الكون من هيدروجين ولا شيء غيره. إرفع هذه النسبة قليلا إلى 0.008 بالمائة والتحول سيكون سريعا جدا لدرجة أن كل الهيدروجين كان سيكون قد نفذ بحلول وقتنا هذا. في أي من الحالتين وبتغيير بسيط جدا في قيمة الرقم فإن الكون كما نعرفه ونحتاجه أن يكون لم يكن ليوجد.
هنا يجب أن نؤكد أن كل شيء مناسب حتى الآن. على المدى الطويل، قد تكون الجاذبية أقوى قليلا مما يجب، يوما ما قد توقف تضخم الكون وتجعله ينهار على نفسه حتى يسحق نفسه مكونا مفردة singularity من جديد، ربما لتبدأ العلمية كلها من جديد. أيضا قد تكون الجاذبية أضعف مما ينبغي وأن الكون سيظل يتسع حتي يصبح كل شيء في الكون بعيدا عن بقية الاشياء، بحيث أنه لن يكون هناك أي فرصة لتفاعل المواد مع بعضها، بحيث يصبح الكون مكان خامل وميت، لكنه شاسع جدا. الاحتمال الثالث أن الجاذبية قيمتها مضبوطة بشكل مثالي- الكثافة المثالية كما يطلق عليها علماء الكونيات- بحيث أنها ستمسك الكون عند الأبعاد المناسبة لتسمح للاشياء بأن تستمر للأبد. علماء الكونيات في بعض الأوقات المرحة يطلقون على هذا تأثير ذات الشعر الاشقر Goldilocks وهو إسم بطلة قصة الأطفال المعروفة ذات الحظ الممتاز، ويعنون بهذا أن كل شيء مضبوط تماما. (كمعلومة الاحتمالات الثلاثة للكون المذكورة تعرف بالترتيب بالكون المغلق و المفتوح و المسطح).
السؤال الذي جال بالتأكيد بعقل كل منا في وقت ما هو: ماذا سيحدث لو سافرت لحافة الكون، ووضعت رأسك خلال الستائر؟ أين ستكون رأسك إذا لم تكن داخل الكون؟ ماذا ستجد وراء هذه الحافة؟ الجواب للاسف، هو أنك لا يمكن أن تجد حافة الكون!. ليس هذا لأن الرحلة ستستغرق أطول من اللازم، رغم أنه من المؤكد أنها ستلتزم وقتا طويلا جدا. لكن لأنه حتي لو أنك سافرت للخارج في خط مستقيم للأبد، بمثابرة فانك لن تصل أبدا للحافة. بدلا من هذا فإنك ستجد نفسك عدت للنقطة التي بدأت منها (غالبا فإنك ستفقد الأمل حينها وتكف عن المحاولة). السبب وراء هذا هو أن الكون ينحني بطريقة لا نستطيع أن نتخيلها تماما، طبقاً لنظرية أينشتاين للنسبية العامة (والتي سنتعرض لها لاحقا). في الوقت الراهن فإنه من الكافي أن ندرك أننا لسنا موجودون داخل فقاعة كبيرة تتسع باستمرار. الأحرى أن الكون ينحني، بشكل يسمح له أن يكون بلا حد لكنه ذا حجم محدود وليس لا نهائي. الفضاء لا يمكن حتي أن نقول أنه يتسع بالضبط، لأنه كما يقول الفيزيائي الحائز علي جائزة نوبل ستيفن واينبرج Steven Weinberg:” المجموعات الشمسية والمجرات لا تتسع والفضاء نفسه لايتسع، بل أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض. أن كل هذا هو تحدي للإحساس الطبيعي لدينا بالأشياء”.
أو كما يقول البيولوجي جي بي أس هولدين J. B. S. Haldane:”إن الكون ليس أغرب مما نعتقد، بل أنه أغرب مما يمكننا أن نعتقد”
المثال الذي يعطي عادة لتقريب هذا الإنحناء للأذهان, هو أن نحاول أن نتخيل شخص من كون مسطح تماما والذي لم ير في حياته أي جسم كروي، ياأتي هذا الشخص للأرض. مهما تنقل هذا الشخص حول سطح الكوكب فإنه لن يجد أبدا حافة له، سيجد نفسه في النهاية عاد للنقطة التي بدأ منها، و طبعا لن يجد أي تفسير للكيفية التي حدث بها هذا. نحن في مثل موقف هذا الكائن إلا أننا نتعامل مع بعد زائد. (لم افهمها)
مثلما أنه لا يوجد مكان تستطيع أن تجد فيه حافة الكون، فإنك أيضا لايمكن أن تقف في مكان وتقول: “هذا هو المكان حيث بدأ كل شيء. هذا هو مركز كل شيء” إننا كلنا في مركز الكون. الحقيقة، نحن لسنا متأكدون تماما من هذا، نحن لا نستطيع إثبات هذا رياضيا. فقط العلماء يفترضون أننا لا يمكن أن نكون بالفعل في مركز الكون، وإنما أن كل مكان في الكون متماثل مع كل الاماكن الاخرى. في النهاية نحن حقيقة لا نعرف.
بالنسبة لنا فإن الكون يمتد حتى المناطق التي سافر فيها الكون منذ بلايين السنين منذ تكون الكون. الكون المرئي- الكون الذي نعرفه و نتحدث عنه- هو مليون مليون مليون مليون أي 1,000,000,000,000,000,000,000,000 ميل من أحد طرفيه للطرف الآخر. لكن طبقا لمعظم النظريات فإن الكون الأعظم – أو ما وراء الكون كما يطلق عليه أحيانا- هو أكبر من ذلك بكثير. طبقا لرييس Rees فإن عدد السنوات الضوئية من هنا حتى حافة الكون سيكتب ليس بعشرات الاصفار، و ليس حتى بمئات منها، بل بملايين (ممكن أن تقول: لن يكتب بعشرات الاصفار ولا حتى بمئات منها، بل بالملايين)). ببساطة فان حجم الكون أكبر مما يمكن أن تتخيل بدون محاولة تخيل المزيد منه.
لفترة طويلة جدا كان في نظرية الانفجار العظيم ثغرة كبيرة جدا ضايقت العديدين، وهي أنها لم تفسر كيف أصبحنا في الحالة التي نحن فيها الآن. رغم أن 98 بالمائة من كل المادة الموجودة الآن تخلقت مع الانفجار العظيم، فان هذه المادة كانت فقط غازات خفيفية: هيليوم، هيدروجين ولييثيوم. أما العناصر الأخرى المهمة جدا لوجودنا مثل الكربون والنيتروجين والأكسجين وكل البقية (العناصر المتبقية) فإنه لم يتكون منها ذرة واحدة لحظة الانفجار العظيم. و لكن- و هذه هي المشكلة- لتكوين مثل هذه العناصر الثقيلة فإنك تحتاج الحرارة والطاقة التي وجدت في لحظات الإنفجار العظيم. ومع هذا لم يحدث إلا انفجار عظيم واحد فقط، و هو لم يكوّن أيا من هذه العناصر. إذن من أين اتت تلك العناصر؟
المثير في الأمر أن الرجل الذي وجد الحل لهذا السؤال هو عالم الكونيات الذي كان يحتقر نظرية الإنفجار العظيم وقد وضع إسم الانفجار العظيم Big Bang لكي يسخر من النظرية ” لكي نشعر بالسخرية في الإسم فاننا يجب أن ننتبه إلى أن الترجمة العربية الأدق له هي الفرقعة العظيمة ولكني أستخدم هنا الترجمة المتعارف عليها أكثر”. سنتناول هذا الرجل بعد قليل لكن قبل أن نجيب علي سؤال كيف وصلنا هنا، يبدو أنه من الأنسب أن نمضي عدة دقائق لكي نتأمل ماذا نقصد بهنا تحديداً.
الفصل الثاني: مرحبا بك في المجموعة الشمسية
يستطيع فلكيو هذه الأيام القيام بأشياء مذهلة حقا. فمثلا إذا أشعل أحدهم عود ثقاب على القمر، يستطيعون لمح هذا اللهب. من أصغر تذبذبات وترنحات أبعد النجوم يستطيعون استقراء حجم وخصائص وحتى إمكانية الحياة على كواكب أبعد من أن ترى؛ كواكب بعيدة جدا لدرجة أننا نحتاج لنصف مليون من الأعوام في مركبة فضاء لنصل هناك. بمراقيبهم “تليسكوباتهم” الراديوية يستطيعون الانصات لهمسات ضئيلة من الإشعاع لدرجة أن كل ما تم جمعه من طاقة من خارج المجموعة الشمسية – بواسطة كل هؤلاء الفلكيون في شكل إشارات منذ أن بدأ الرصد في عام 1951م – “أقل من طاقة ندفة ثلج تصطدم بالأرض” كما يقول كارل سيجان “Carl Sagan”.
باختصار، لا يوجد الكثير مما يحدث في الكون لا يستطيع الفلكيون رصده، عندما يريدون ذلك. وهو ما يجعل الأمر أكثر غرابة أن نعرف أنه حتى عام 1978م لم يكن أحد قد لاحظ أن لبلوتو قمر. ففي صيف ذلك العام، كان الشاب جايمس كريستي “James Christy” في مرصد البحرية الأمريكية في فلاجستاف “Flagstaff” بأريزونا، كان يقوم بمراجعة روتينية لصور فوتوغرافية لبلوتو، عندما لاحظ وجود شيء ما؛ شيء ضبابي وغير واضح لكن مؤكد أنه شيء منفصل عن بلوتو. وباستشارته لزميله روبرت هارينجتون “Robert Harrington”، استخلص أن ما كان يراه هو قمر. ولم يكن أي قمر. فنسبة إلى حجم الكوكب، كان هذا أكبر قمر في المجموعة الشمسية.
كانت هذه ضربة لمكانة بلوتو ككوكب، وهي مكانة لم تكن صلبة علي أية حال. وبما أنه في السابق كان يعتقد أن بلوتو وقمره هما جسم واحد، فإن هذا يعني أن بلوتو فعليا أصغر بكثير مما اعتقد الفلكيون انذاك، اصغر حتى من عطارد؛ بل إن أكبر سبعة أقمار في مجموعتنا الشمسية بما فيها قمرنا أكبر من بلوتو نفسه.
السؤال البديهي هو لماذا تطلب الأمر كل هذا الوقت ليجد أحدهم قمرا في مجموعتنا الشمسية ذاتها. جزء من الاجابة هو مسألة أين يوجه الفلكيون معداتهم، وجزء اخر هو ما ما أعدت معداتهم لترى، والجزء الاخير انه فقط بلوتو. السبب الاكبر هو أين يوجهون معداتهم؟. يقول الفلكي كلارك تشابمان “Clarck Chapma”: “معظم الناس يعتقدون أن الفلكيون يخرجون لمراصدهم ليلا ويمسحون السماء. هذا ليس صحيحا. تقريبا كل ما لدينا من مراقيب صمم لكي يمعن النظر في بقعة صغيرة جدا من السماء على مسافة بعيدة جدا لكي يرى كوازار “Quasar” أو لكي يحاول صيد الثقوب السوداء أو ينظر لمجرة بعيدة. الشبكة الوحيدة من المراقيب التي صممت لمسح السماء صممها وبناها الجيش.”
لقد دللنا الفنانون، برسومهم التي الصقت بخيالنا صور لها وضوح لا يوجد في علم الفلك الحقيقي. فـ بلوتو في صورة كريستي مشوش ولا يكاد يلاحظ، وقمره ليس ذلك الرفيق المضاء بشاعرية والمحدد بدقة، الذي قد تجده في لوحة من مجلة الناشونال جيوجرافيك “National Geographic”، بل الأحرى أنه فقط نقطة صغيرة لا تميز محاطة بمزيد من التشوش. لقد كانت صوره بهذه الدرجة من التشوش لدرجة أن الأمر احتاج لسبع سنوات أخرى لكي يراه أي شخص آخر بهذا يؤكد وجوده بشكل مستقل.
الشيء الطريف في اكتشاف كريستي هو أنه حدث في فلاجستاف، لأنه هناك في نفس المرصد في 1930م أكتشف بلوتو نفسه لأول مرة. يعود الفضل هذا الاكتشاف المحوري في الفلك إلى الفلكي برسيفيل لايل “Percival Lowell”. لايل، والذي جاء من إحدى أقدم وأغني عائلات بوسطون أعطي اسمه للمرصد الشهير، لكن اسمه يرتبط أكثر بأنه صاحب الاعتقاد أن المريخ مغطى بقنوات أقامها رجال الصناعة المريخيون لنقل الماء من القطبين إلى المناطق الأكثر جفافا ولكن الأكثر (والأكثر) إنتاجية قرب خط الإستواء.
قناعة لايل الأخرى هي وجود كوكب آخر بعد نبتون، كوكب تاسع لم يكتشف بعد آنذاك، أسماه الكوكب X. بني لايل هذا الاعتقاد على عدم الأنتظام الذي لاحظه هو في مساري اورانوس ونبتون، وقد خصص سنوات حياته الأخيرة لمحاولة البحث عن هذا العملاق الغازي، الذي كان يؤمن بوجوده. ولكن للأسف، فقد مات فجأة في 1916م، متأثرا جزئيا بالإرهاق الذي نجم عن بحثه الدؤوب، وقد سقط البحث في غياهب النسيان المؤقت بينما تصارع ورثة لايل على تركته. في عام 1929م جزئيا لكي يلفتوا الانتباه بعيدا عن قصة قنوات المريخ – والتي كانت بحلول هذا الوقت قد أصبحت مصدرا كبيرا للإحراج – قرر مديرو مرصد لايل استكمال البحث ولهذا الغرض عينوا شابا من كانساس اسمه كلايد تامبا “Clyde Tombaugh”.
تامبا لم يكن لديه أي تدريب رسمي كفلكي، لكنه كان مثابرا وحاذقا، وبعد عام من البحث المتأني وجد بلوتو بشكل ما، نقطة خافتة من الضوء في سماء مليئة بالنقاط اللامعة. لقد كان كشفا خارقا، والذي جعله صادما أكثر أن التنبؤات التي وضعها لايل حول هذا الكوكب تبين أنها خاطئة تماما. لقد لاحظ تامبا فورا أن الكوكب الجديد لم يكن يشبه كرة الغاز العملاقة التي افترض لايل وجودها، لكن أي تحفظات كانت لديه أو لدى أي شخص آخر عن طبيعة هذا الكوكب الجديد اختفت تحت شلال الانبهار والذي صاحب أي قصة كبيرة في ذلك العصر الذي تميز بسهولة ابهار معاصريه. هذا كان أول كوكب أمريكي الاكتشاف، ولم يكن أحد على استعداد لأن يشغل نفسه بحقيقة أنه لم يكن أكثر من نقطة بعيدة متجمدة. أحد العوامل التي رجحت اسم بلوتو هو أن أول حرفين من الاسم هم اختصار اسم برسيفال لايل. لقد نودي بلايل بعد وفاته في كل مكان كعبقري من الطراز الاول، بينما تامبا نسي إلى حد كبير إلا بين فلكيو الكواكب، والذين يحترمونه احتراما كبيرا.
عدد قليل من الفلكيين لا زال يعتقد بوجود كوكب X، كوكب جبار ربما بلغ حجمه عشرة أضعاف حجم المشتري لكنه بعيد جدا عن الشمس لدرجة تجعله خفيا عنا. كما أنه يسقط عليه كما صغيرا جدا من الضوء مما سيجعله لا يعكس شيئا تقريبا. الفكرة هي أنه لن يكون كوكبا تقليديا كزحل أو المشتري، إنه بعيد جدا بدرجة تجعل ذلك مستحيلا، إننا نتحدث عن مسافة في حدود أربعة ونصف تريليون من الأميال، لكنه أقرب لشمس لم تنجح تماما. معظم النظم النجمية في الكون هي نظم مزدوجة (ثنائية الشموس)، مما يجعل شمسنا الوحيدة غريبة بعض الشيء.
أما عن بلوتو نفسه فلا أحد متأكد تماما من حجمه، أو مما صنع، أو من نوع الغلاف الجوي الذي يحيط به، أو حتى ما هو أصلا. العديد من الفلكيين يعتقدون أنه ليس كوكبا على الاطلاق، بل إنه فقط أكبر جرم يوجد في مجال من الحطام المجري يعرف بحزام كويبر “Kuiper Belt”. لقد توقع وجود هذا الحزام نظريا الفلكي ف. س. لوينارد “F. C. Leonard” في عام 1930م، إلا أن الاسم هو تكريم لجيرارد كويبر Gerard Kuiper، عالم نمساوي كان يعمل في أمريكا والذي أضاف للنظرية. حزام كويبر هو مصدر ما يعرف بمذنبات الدورة القصيرة – وهي تلك التي تمر بشكل منتظم- ومن أشهرها مذنب هالي. أما المذنبات الأكثر انعزالا فـ وهي مذنبات الدورة الطويلة (من بينهم مذنبي هايل بوب Hale-Bopp، وهياكوتاكي Hyakutake) والذين أتيا من سحابة أورت Oort cloud الأكثر بعدا.
الحقيقة أن بلوتو لا يتصرف مثل بقية الكواكب. ليس فقط لكونه صغيرا وبعيدا، بل لأن حركته غير منتظمة لدرجة أنك لا تستطيع أن تعرف أين سيكون خلال قرن من الآن. وبينما بقية الكواكب تدور كلها في نفس المستوى، فإن مدار بلوتو مائل بسبعة عشر درجة، كقبعة مائلة بأناقة علي رأس احدهم. مداره غير منتظم لدرجة أنه لفترات طويلة من دورانه حول الشمس يكون أقرب لنا من نبتون. لقد كان نبتون في معظم فترة الثمانينيات والتسعينيات أبعد كواكب المجموعة الشمسية. ولم يعد بلوتو للمدار الخارجي إلا في 11 فبراير 1999م، ليبقي فيه لل (حتى الـ )228 سنة القادمة.
إذن لو كان بلوتو حقا كوكب، فإنه بالتأكيد كوكب غريب. إنه صغير جدا: فقط ربع الواحد بالمائة من حجم الارض. إذا وضعته فوق الولايات المتحدة، فإنه بالكاد سيغطي بالكاد الولايات الثمانية والاربعين الدنيا. هذا وحده يجعله حالة شاذة للغاية، لأنه يعني أن مجموعتنا الكوكبية تتكون من أربعة كواكب صخرية داخلية، وأربعة عمالقة غازية خارجية، وكرة ثلج صغيرة وحيدة. الأكثر من هذا أننا لدينا العديد من الأسباب لنعتقد أننا يمكن أن نبدأ قريبا في العثور على كرات ثلجية أكبر من بلوتو نفسه في نفس المنطقة من الفضاء. عندها ستكون لدينا مشكلة. بعدما لمح كريستي قمر بلوتو، بدأ الفلكيون بالنظر لهذه البقعة من الكون باهتمام أكبر وبحلول ديسمبر 2002م عثروا على أكثر من 600 جسم ما بعد نبتونيTrans Neptunian، أو بلوتينوهات Plutinos كما يطلق عليها أيضا. أحد هذه الأجسام ويسمي فارونا Varuna تقريبا بحجم قمر بلوتو. يعتقد الفلكيون الآن أنه ربما يكون هناك بلايين من تلك الاجسام. الصعوبة تكمن في أن معظمهم حالك جدا. عادة ما تتراوح الألبيدو Albedo الخاصة بهم – الألبيدو: هومقياس لكمية الضوء المنعكس عنهم – حول الأربعة بالمائة تقريبا مساوية لانعكاسية الفحم، وبالطبع هذه الكتل تبعد حوالي أربعة بلايين ميل عنا.
هل نشعر حقا بمقدار هذه البلايين الأربعة من الأميال. إنها أكثر مما يمكننا أن نتخيل. إن الفضاء حقا هائل الضخامة. لنتخيل، فقط للفهم والتسلية، أننا على وشك الإقلاع في رحلة بمركبة صاروخية. إننا لن نذهب بعيدا، فقط لطرف مجموعتنا الشمسية، لكننا نحتاج أولا أن نحدد كبر الفضاء وصغر الحجم الذي نحتله نحن منه.
الخبر السيء هو أننا لن نعود في ميعاد مناسب لتناول طعام العشاء. حتى بسرعة الضوء، سنحتاج لسبع ساعات كاملة لنصل لبلوتو. لكننا لا نستطيع بالطبع أن نصل لأي سرعة قريبة من هذا. لذا فإننا سنضطر أن نسير بسرعة الصواريخ، وهذه أبطأ كثيرا. حيث أن أسرع سرعة حققها أي جسم بناه انسان حتى الان هي سرعة المركبتين فوياجر 1 و 2 “Voyager 1 and 2” اللتين تحلقان الان مبتعدتان عنا بسرعة تبلغ خمسا وثلاثين ألفا من الأميال في الساعة تقريبا.
والسبب في اختيار وقت إقلاع المركبتين فوياجر (أغسطس وسبتمبر من عام 1977م) هو أن المشتري وزحل وأورانوس ونبتون كانوا جميعا مصطفين بشكل يحدث مرة واحدة كل 175 عام. هذه الظاهرة سمحت لفوياجر أن تستخدما دفعة جذبوية Gravity Assist، بحيث تدفع كل مركبة من كوكب للكوكب التالي، ومع هذا فقد استلزم الأمر تسع سنوات لتبلغا أورانوس ودستة من الأعوام لكي تعبرا مدار بلوتو. الجيد في الأمر أننا لو اخترنا يناير من عام 2006 كميعاد لانطلاقنا (وهو ميعاد انطلاق سفينة ناسا New Horiznos المتجهة لبلوتو) فإننا نستطيع الإفادة من موقع المشتري المناسب، بالإضافة لبعض التحسن في التكنولوجيا، ونختصر زمن الرحلة لعقد واحد، لكن العودة مرة أخرى ستطلب (ستتطلب) وقتا أكبر من ذلك. على أي حال فإنها ستكون رحلة طويلة.
أول شيء ستلاحظه هو أن كلمة الفضاء تناسب وصف الفضاء بالفعل، وأنه الفضاء لا يحدث فيه شيء تقريبا. مجموعتنا الشمسية قد تكون أكثر الأماكن نشاطا لتريليونات الأميال، لكن كل الأشياء المرئية فيها – الشمس والكواكب وأقمارهم والبليون جسم المكونة لحزام الكويكبات وكل الأشياء الأخرى السابحة حول الشمس – تحتل أقل من 1 من التريليون من الحجم المتاح في المجموعة الشمسية. انك أيضا تدرك سريعا أن كل خرائط المجموعة الشمسية التي رأيتها في حياتك لم تقترب حتى من تمثيل المجموعة الشمسية بمقياس رسم صحيح. معظم مخططات المجموعة الشمسية المدرسية تبين الكواكب احدها بعد الاخر بمسافات تسمح لهم بأن يكونوا جيران لدرجة أن بعض هذه المخططات ترسم ظلال لبعضها فوق الاخرين (فوق الكواكب الأخرى) – لكن هذا خداع ضروري لكي نضعهم كلهم على قطعة ورق واحدة. نبتون في الواقع ليس فقط أبعد قليلا من المشتري، انه على بعد هائل منه، انه أبعد من المشتري بـ خمس مرات أكثر من بعد المشتري عنا، بعيد لدرجة أنه يستقبل 3 بالمائة مما يستقبل المشتري من ضوء الشمس.
ان هذه المسافات هائلة جدا لدرجة أنه لا يمكن بطريقة عملية رسم المجموعة الشمسية بمقياس رسم صحيح. حتى لو أضفنا الكثير من الورق المطوي لكتابك المدرسي أو استخدمنا قطعة ورق طويلة جدا، فإننا لن نقترب حتى من هذا. (فمثلا لو استخدمنا مخطط …..) في مخطط للمجموعة الشمسية بمقياس رسم صحيح، (وقمنا برسم) إذا رسمت الأرض بحجم حبة البازلاء، فإن المشتري سيكون على بعد أكثر من ألف قدم، أما بلوتو فسيكون على بعد ميل ونصف (وسيكون حجمه قريب من حجم البكتيريا بحيث أنك لن تراه أصلا). وبنفس مقياس الرسم، فإن بروكسيما سنتوري، أقرب نجم لنا سيكون على بعد عشرة ألآف ميل. حتى لو انكمش كل شيء بحيث يصبح المشتري بحجم النقطة في نهاية هذه الجملة، وبلوتو بحجم الجزيء، فإن بلوتو سيظل على بعد خمس وثلاثين قدما.
اذن المجموعات الشمسية حقا هائلة. حينما نصل لبلوتو فإن شمسنا الحبيبة المانحة للحياة والدفء – ستكون بالنسبة لنا أصغر من رأس الدبوس. إن الشمس من موقعنا الجديد هذا لا تزيد عن نجم ساطع في السماء مثل بقية النجوم. في مثل هذا الفراغ الوحيد يمكنك أن تدرك كيف أن أجسام بحجم قمر بلوتو قد تهرب من نظرنا. في هذا المضمار بلوتو ليس وحيدا أبدا، إلى أن وصلت لنا اكتشافات رحلة فوياجر، كان يعتقد أن لنبتون قمرين، فوياجر وجدت ستة أقمار إضافية. عندما كنت طفلا (كان يعتقد أن المجموعة الشمسية بها ….) فإن المجموعة الشمسية كان يعتقد أن بها ثلاثون قمرا. المجموع الآن هو تسعون على الأقل، وثلث هذه الأقمار لم يعثر عليه إلا في آخر عشر سنوات.
لذا فإنه من المهم أن نتذكر ونحن نتخيل الكون أننا لا نعرف ما يوجد بالضبط في مجموعتنا الشمسية نفسها.
الشيء الاخر الذي ستلاحظه ونحن نمرق بجانب بلوتو هو أننا نمرق بجانب بلوتو. إذا راجعت دليل رحلتنا، ستجد أننا متجهون لحافة المجموعة الشمسية، وللأسف فإننا لم نصل لهناك بعد. بلوتو قد يكون اخر جسم يحظى بعلامة على المخططات المدرسية، لكن المجموعة الشمسية لم تنته بعد. في الواقع إننا حتى لم نقترب من نهايتها. إننا لن نصل لنهايتها حتى نعبر سحابة أورت Oort Cloud، وهي مملكة سماوية شاسعة من المذنبات السابحة. واسف أن أعلمكم أننا لن نصل لسحابة أورت إلا بعد عشرة ألآف عام. إن بلوتو كما نرى بالكاد 1 من خمسين ألف من المسافة.
بالطبع فإنه لا أمل لنا في قطع مثل تلك الرحلة. ان رحلة ال 240 ألفا من الأميال للقمر لا زالت تمثل لنا جهدا شاقا. إن فكرة إرسال بشريين للمريخ والتي أعلنها الرئيس بوش الأب في لحظة اندفاع، قد أسقطت بهدوء عندما أدرك أحدهم أنها ستكلف 450 بليون دولار وستنتهي غالبا بموت الطاقم (بتمزق ال DNA الخاص بهم تحت تأثير الجسيمات الشمسية عالية الطاقة والتي لا يمكن حمايتهم منها).
طبقا لما نعرف الان وما يمكننا أن نتخيل منطقيا، فإنه لا يوجد أي أمل أن يصل أي بشري إلى أطراف مجموعتنا الشمسية، أبدا. إنه أبعد من اللامكان. حتى باستخدام تليسكوب هابل، لا نستطيع أن نبصر داخل سحابة أورت (من الممكن اضافة معلومة اختراع شبكة جيمس تلسكوب والتي ستستطيع الابصار داخل السحب والسدم السماوية)، لذا فإننا حتى لا نعرف إن كانت موجودة حقا. إن وجودها محتمل لكنه افتراضي تماما.*
كل ما يمكنه (يمكننا) أن نقوله بثقة عن سحابة أورت أنها تبدأ في مكان ما بعد بلوتو وتمتد لمسافة سنتين ضوئيتيين. مسافة القياس الأساسية في الكون هي الوحدة الفلكية AU والتي تمثل المسافة من الشمس للأرض. (بالتالي فإن بلوتو يبعد) يبعد بلوتو عنا حوالي أربعون وحدة فلكية، أما قلب سحابة أورت فيبعد خمسون ألف وحدة فلكية. إنها ببساطة نائية.
لكن دعونا نتخيل أننا وصلنا لسحابة أورت. أول شيء ستلاحظه هو كم الهدوء هنا. إننا بعيدون عن أي شيء هنا. الشمس بعيدة عنا جدا لدرجة أنها لم تعد حتى أكثر النجوم سطوعا في السماء. إنه أمر مبهر أن نفكر أن هذه الومضة الضعيفة لديها ما يكفي من الجاذبية للامساك بكل هذه المذنبات في مداراتها. إنها ليست رابطة قوية، لذا فإن المذنبات تسبح بشكل منتظم، بسرعة 220 ميل في الساعة. من وقت لاخر، بعضا من هذه المذنبات الوحيدة يدفع خارج مداره الطبيعي بواسطة رعشة جذبوية بسيطة- ربما نجم مار. أحيانا يقذفون لفراغ الفضاء، حيث لن نراهم ثانية. و لكن أحيانا يسقطون في مدار طويل حول الشمس. حوالي ثلاثة أو أربعة من هذه كل عام – تعرف بمذنبات الفترة الطويلة – تعبر الجزء الداخلي من المجموعة الشمسية. وأحيانا يصطدم أحد هؤلاء الزوار الضالون بجسم صلب، مثل الأرض. وهذا هو سبب مجيئنا لهنا الآن – لأن المذنب الذي جئنا لنراه، قد بدأ (في رحلة) سقوط طويل نحو مركز المجموعة الشمسية. من بين كل الأماكن التي يمكن أن يبلغها فإنه يتجه نحو مدينة ماسون بولاية أيوا. سيتطلب الأمر وقتا طويلا، حوالي ثلاثة أو أربعة ملايين من الأعوام على الأقل، لذا فإننا سنتركه الان، مع وعد بالعودة له لاحقا.
إذن هذه هي مجموعتنا الشمسية. ماذا يوجد بعدها؟ لا شيء والكثير حسبما تنظر للامر.
على المدى القصير، لا شيء. أفضل فراغ صنعه انسان ليس فارغا كالفراغ بين الكواكب. ويوجد الكثير من هذا اللاشيء حتى تصل لأي شيء اخر. أقرب جار لنا في الكون، بروكسيما سنتوري Proxima Centauri، وهو نجم من نظام نجمي ثلاثي النجوم يدعي ألفا سنتوري Alpha Centauri، يبعد عنا 4.3 سنة ضوئية، وهي مسافة تافهة بمقياس المجرة، لكنها أكبر بمائة مليون مرة من رحلتنا للقمر. لنصل لها بسفن الفضاء سيتطلب الأمر على الاقل خمس وعشرون ألفا من الأعوام، وحتى لو قمت بالرحلة فإنك لن تصل إلا إلى مجموعة منعزلة من النجوم في وسط اللاشيء. لتصل لأقرب علامة مهمة بعد ذلك، سيرياس Sirius، سيتطلب 4.6 سنة ضوئية إضافية من الترحال. وهكذا سيستمر الأمر لو حاولت أن تقفز من نجم لآخر خلال الكون. الوصول لمركز مجرتنا نفسها سيتطلب وقتا يفوق الوقت الذي وجد فيه البشر ككائنات.
الفضاء دعوني اكرر، شاسع. المسافة المتوسطة بين النجوم 20 مليون مليون ميل. حتى بسرعات تقترب من سرعة الضوء، فإن هذه مسافات لا يستهان بها. بالطبع فإنه من الممكن أن تسافر كائنات فضائية لبلايين الأميال لكي يسلو أنفسهم بتكوين دوائر خالية من الزروع Crop Circles في ويلتشاير أو لكي يفزعوا لدرجة الموت شخص مسكين في شاحنة على طريق منعزل في أريزونا (لأنه من المؤكد أن لدى هذه الكائنات بعضا من المراهقين)، لكنه يبدو أن هذا مستبعد.
إحصائيا إمكانية وجود كائنات عاقلة في الكون جيدة. لا أحد يعرف عدد النجوم بالتحديد في مجرتنا – تتراوح التقديرات بين 100 بليون و400 بليون – والطريق اللبني مجرد واحدة من 140 بليون مجرة اخرى، الكثير منهم أكبر من مجرتنا. في الستينيات حفزت مثل هذه الأرقام الهائلة، عالم من كورنيل Cornell يدعي فرانك دريك (دريك أم ديراك؟؟) Frank Drake، أن يقوم بنشر معادلة شهيرة صممت لحساب إحتمالية الحياة المتطورة في الكون بناءا على سلسلة من الاحتمالات المتناقصة.
طبقا لمعادلة دريك فإنك تقسم عدد النجوم في منطقة من الفضاء على عدد النجوم التي يحتمل أن يكون لها كواكب تابعة، اقسم هذا الرقم الاخير على عدد الكواكب التي من الممكن أن تدعم نظريا وجود حياة، اقسم هذا على عدد الكواكب الذي (التي) إن نشأت عليه (عليها) الحياة ستتطور لدرجة من الذكاء، وهكذا. عند كل قسمة من هذه ينخفض الرقم بشكل هائل. مع هذا وحتى بأكثر الافتراضات تحفظا فإن عدد الحضارات المتقدمة في مجرتنا وحدها سيكون في نطاق الملايين.
يالها من فكرة مثيرة. ربما نكون نحن واحدة من ملايين الحضارات المتقدمة. للأسف، ومع كون الفضاء متسع بهذا الشكل، فإن المسافة المتوسطة بين أيا من هذه الحضارات، سيكون حوالي 200 سنة ضوئية، وهو رقم أكبر بكثير مما يبدو. انه يعني انه حتى لو أن تلك الكائنات تعرف موقعنا ويستطيعون بشكل ما أن يرونا بتيلسكوباتهم، فإنهم يشاهدون ضوءا ترك الأرض منذ مائتي عام. لذا فإنهم لا ينظرون إلينا نحن. أنهم يشاهدون الثورة الفرنسية وتوماس جيفرسون Thomas Jefferson وأناس يرتدون جوارب طويلة حريرية وباروكة بيضاء. أناس لا يعرفون ماهية الذرة، ولا الجينات، والذين يصنعون الكهرباء بحك قضيب من الكهرمان بقطعة من الفراء ويعتقدون أن هذا يعد انجازا. إن أية رسالة تصل لنا من مثل تلك الكائنات الفضائية يتوقع أن تبدأ بعبارة مثل “يا مولاي” “Dear Sire” وتهنئنا على وسامة جيادنا وعلى تمكننا من فن التعامل مع زيت الحيتان. إن مسافة مائتي سنة ضوئية بعيدة لدرجة تجعلها لا نهائية بالنسبة لنا.
إذن حتى لو لم نكن فعليا وحدنا فإننا عمليا وحدنا. لقد قام كارل سيجان Carl Segan بحساب عدد الكواكب المحتملة في الكون ووصل لرقم 10 بليون تريليون كوكب. رقم يفوق التخيل بمراحل. ولكن الذي يفوق التخيل بنفس القدر هو مقدار الفضاء الذي تتوزع فيه هذه الكواكب. “لو أننا وضعنا في أي مكان في الكون بشكل عشوائي” يقول سيجان، “احتمال أن نكون على أو بالقرب من كوكب، هي أقل من 1 في بليون تريليون تريليون” (أي 10 مرفوعة لأس 33 أو واحد يعقبه ثلاثة وثلاثون صفرا.) “الكواكب ثمينة.”
لذا فإنه من الجيد أنه في فبراير 1999م قرر الاتحاد الفكلي الدولي رسميا أن بلوتو يعد كوكبا. إن الكون مكان متسع جدا ومنعزل. ونحن نرحب بأي جيران نستطيع أن نجدهم. و بهذا ينتهي الفصل الثاني و سابدأ بنشر الفصل الثالث قريبا ان شاء الله.
الفصل الثالث: كون المبجل "إيفانز"
عندما تصفو السماء، ويكون القمر متواريًا، يحمل المبجل “روبرت إيفانز” (Robert Evans) أو اختصارًا “بوب إيفانز”، الرجل الهادئ المرح، تليسكوبه الضخم ويضعه في الشرفة الخلفية لمنزله الكائن بالجبال الزرقاء الأسترالية، حوالي خمسين ميلاً غرب سيدني، ويقوم بنشاط استثنائي. إنه ينظر في أغوار الماضي السحيق ويجد نجومًا تحتضر.
النظر للماضي هو بالطبع الجزء السهل من الموضوع. ألقِ نظرة عابرة على السماء ليلاً وما تراه هو التاريخ والكثير منه. النجوم ليست كما هي الآن، بل كما كانت حين تركها ضوءها. على قدر علمنا النجم الشمالي، رفيقنا الوفي، قد يكون احترق عن آخره في يناير الماضي أو في عام 1854، أو في أي وقت منذ بداية (القرن الرابع عشر) وخبر ذلك لم يصلنا بعد. أفضل تخمين لدينا هو أنه كان لا يزال يحترق في مثل هذا اليوم منذ (680 عامًا). النجوم تموت طوال الوقت. ما يقوم به “بوب إيفانز” أفضل من أي شخص آخر، هو اصطياد لحظات الوداع السماوية تلك.
بالنهار، “إيفانز” قس طيب ونصف متقاعد الآن في كنيسة توحيدية (Uniting Church) بأستراليا، يقضي وقته في البحوث التاريخية الحرة حول الحركات الدينية خلال القرن التاسع عشر. وفي الليل – بطريقته الخاصة- فإنه عملاق من عمالقة السماء، إنه يصيد “السوبرنوفا”.
“السوبرنوفا” تحدث عندما ينهار أحد النجوم الأكبر من نجمنا بكثير، ثم ينفجر بقوة، محررًا في لحظة طاقة تعادل الطاقة التي تنطلق من مائة بليون نجم في أوقات احتراقها العادية، ويظل لفترة يضيء بسطوع أعلى من كل نجوم المجرة مجتمعين. “إنه مثل تريليون قنبلة هيدروجينية تنفجر كلها معًا” يقول “إيفانز”. لو حدث انفجار “سوبرنوفا” في نطاق خمسمائة سنة ضوئية من موقعنا، فإننا سنكون ضائعين لا محالة. طبقًا لـ”إيفانز” فإن هذا “سينهي الأمر”. لكن الكون شاسع، وانفجارات “السوبرنوفا” عادة ما تكون أبعد من أن تؤذينا. في الواقع فإن معظمها بعيد جدًا لدرجة أن ضوءها يصل إلينا في شكل لمعان خفيف. لفترة الشهر تقريبًا الذي تكون فيه مرئية، كل ما يميز السوبر نوفا عن بقية النجوم هو أنها تحتل نقطة في السماء كانت خالية من قبل. إنها تلك النقاط الشاذة في كرة السماء المزدحمة التي يجدها المبجل “إيفانز”.
مصطلح “السوبرنوفا” صاغه خلال الثلاثينيات عالم فلك غريب الأطوار يدعى “فريتز زويكي”. “زويكي” الذي وُلد في “بلغاريا” ونشأ في “سويسرا” جاء إلى “معهد التقنية” “بكاليفورنيا” (California Institute of Technology)* في العشرينات، وعلى الفور ميّز نفسه بين أقرانه بشخصيته الحادة ومهاراته غريبة الأطوار. لم يبد عليه أنه لامع الذكاء بشكل خاص، ومعظم زملائه لم يعتبروه أكثر من “مهرج مزعج”. كونه مولع بأمور اللياقة البدنية، فإنه كان كثيرًا ما يستلقي أرضًا فجأة في صالة طعام المعهد أو أي مكان عام آخر، ويقوم بأداء تمرين الضغط بيد واحدة ليثبت لياقته البدنية لأي شخص يبدو عليه عدم اقتناعه بها. كان معروفًا بعدوانيته، بحيث أصبحت تصرفاته في النهاية مخيفة بشكل جعل أكثر زملائه تعاونًا معه في العمل – وهو رجل هادئ ومتحضر يدعى “والتر بادا” (Walter Baade) – يرفض أن يُترك وحده معه. من بين أشياء أخرى، اتهم “زويكي” زميله “بادا” الألماني بالنازية، الأمر الذي لم يكن صحيحًا بالطبع. وفي موقف واحد على الأقل هدد “زويكي” بقتل “بادا” لو رآه مرة أخرى في حرم المعهد، علمًا أن بادا كان يعمل أعلى التل المجاور للمعهد بمرصد “ماونت ويلسون” (Mount Wilson Observatory).
لكن “زويكي” أيضًا كان يتمتع ببصيرة علمية ذات عبقرية لا تُصدق. ففي بداية الثلاثينات وجه اهتمامه نحو السؤال الذي حيّر الفلكيين طويلاً، وهو ظهور نقاط مضيئة لا تفسير لها في السماء، نجوم جديدة. تساءل “زويكي” ما إذا كان “النيوترون” في قلب هذا الأمر.
النيترون هو جسيم تحت ذري كان آنذاك قد اكتشف حديثًا بإنجلترا على يد “جيمس شادويك” (James Chadwick) – وبالتالي كان موضوعًا جديدًا ومعاصرًا. خطر له أن انهيار نجم بحيث تصبح كثافته مقاربة لتلك الموجودة بقلب أنوية الذرات، سينتج جسمًا مضغوطًا بشكل لا يصدق. أنوية هذا النجم ستُسحق معًا بشكل حرفي، وتجبر إليكتروناتها على الالتحام بالنواة، مكونة “نيوترونات”**. سيكون لديك “نجم نيوتروني”. تخيل مليون قذيفة مدفع ثقيلة مضغوطين معًا لحجم بلية و…. حسنًا أنت لست حتى قريبًا من تخيل كثافة “النجم النيوتروني”. قلب “النجم النيوتروني” كثيف لدرجة أن ملعقة واحدة منه تزن حوالي (مائة بليون كيلوجرام). مجرد ملء ملعقة منه! لكن الأمر كان أعمق من هذا بكثير. أدرك “زويكي” أنه بعد انهيار نجم كهذا سيتبقى كمّ هائل من الطاقة، كمّ كافٍ لإحداث أكبر فرقعة في الكون. وهكذا أطلق على هذه هذه الانفجارات اسم “سوبرنوفا”؛ إنها أكبر الأحداث في الكون.
في (الخامس عشر من يناير عام 1934) نشرت مجلة الـ (Physical Review) ملخصًا لمحاضرة قدمها “زويكي” و”بادا” في الشهر السابق بجامعة “ستانفورد”. بالرغم من اختصارها الشديد – فهي فقرة واحدة مكونة من أربعة وعشرين سطرًا – فقد احتوت على كمّ هائل من الجديد في العلم. فقد كانت أول إشارة لكل من “السوبرنوفا” و”للنجم النيوتروني”، وأيضًا فقد شرحت بطريقة مقنعة طريقة تكوّنهم، كما أنها حسبت بطريقة صحيحة حجم الانفجار المصاحب لهم، وكهدية إضافية ربطت بين انفجارات “السوبرنوفا” وتكوّن ظاهرة كانت غامضة آنذاك تُعرف “بالأشعة الكونية” (Cosmic Rays)، والتي لوحظ انها تملأ الكون. هذه الأفكار كانت ثورية جدًا على أقل تقدير. “النجوم النيوترونية” لم يتأكد وجودها إلا بعد أكثر من أربعة وثلاثين عامًا. فكرة “الأشعة الكونية” والتي تُعد الآن محتملة جدًا، لم يتأكد وجودها بعد. وصف الفلكي “كيب ثورن” (Kip thorne) هذا الملخص بأنه “أحد أكثر الوثائق تبصرًا في تاريخ الفيزياء والفلك”.
الطريف في الأمر أن “زويكي” لم يكن لديه أي فهم عن سبب حدوث أي من هذه الظواهر. طبقًا لـ “ثورن”، “إنه لم يكن لديه الإلمام الكافي بقوانين الفيزياء لكي يُثبت أفكاره رياضيًا وفيزيائيًا”. موهبة “زويكي” كانت في الأفكار الكبيرة والمدهشة. أما مهمة الإثبات الرياضي فقد كان “بادا” يتولاها عادة.
“زويكي” كان أيضًا أول من لاحظ أنه لا يوجد كمّ كافٍ من الكتلة المرئية في الكون لكي تُمسك المجرات معًا، وأنه لابد من وجود تأثير جذبوي آخر يساهم في هذا، وهو ما يُعرف الآن بـ “المادة المظلمة”. الشيء الوحيد الذي فشل في أن يلاحظه هو أنه لو تقلص نجم نيوتروني لدرجة كافية فإنه سيصبح كثيفًا لدرجة أن الضوء نفسه لن يستطيع الإفلات من قبضته الجذبوية. سيكون لديك ثقب أسود. للأسف، معظم زملاء “زويكي” كانوا يضعونه في مكانة وضيعة – علميًا – لدرجة أن أفكاره لم تجذب أي اهتمام تقريبًا. عندما سلط “روبرت أوبنهايمر” العظيم الضوء نحو النجوم النيوترونية بعد “زويكي” بخمس سنوات كاملة، في ورقة بحثية تعد علامة في تاريخ العلم، لم يضع إشارة واحدة لأي من أبحاث “زويكي”، رغم أن “زويكي” كان يعمل لسنوات في نفس المشكلة في مكتب في نهاية نفس الرواق الذي يحمل مكتب “أوبنهايمر”. استنتاجات “زويكي” بشأن المادة المظلمة لم تجذب اهتمامًا جديًا لما يقرب من أربعة عقود. يمكننا فقط أن نفترض أن “زويكي” قام بالعديد من تمارين الضغط خلال هذه الفترة.
لنفهم وزن هذا الإنجاز، تخيل طاولة عشاء تقليدية يغطيها مفرش أسود وأحدهم يرش حفنة من الملح عبره. تمثل هذه الحبات المتناثرة المجرات. الآن تخيل ألف وخمسمائة طاولة كهذه، عدد كافٍ لملء ساحة انتظار السيارات في “كارفور”، أو ما يكفي لعمل خط متصل من الطاولات بطول يبلغ ميلين كاملين، كل منها تحمل على سطح مفرشها الأسود حفنة عشوائية من حبيبات الملح. الآن أضف ذرة واحدة من الملح لأي من هذه الطاولات، ودع “بوب إيفانز” يمشي بينها، وبنظرة عابرة سيجدها، حبة الملح الزائدة هذه هي “السوبرنوفا”.
إن “إيفانز” موهبة فذة لدرجة أن “أوليفر ساكس” (Oliver Sacks)، في كتابه “عالم أنثروبولوجيا على المريخ” يخصص فقرة للحديث عنه في فصل عن العباقرة التوحديون (Autistic savants)، مضيفًا أنه لا يقترح أن “إيفانز” يعاني من التوحد. “إيفانز” والذي لم يلتق بـ “ساكس”، يضحك من اقتراح أنه عبقري أو يعاني من التوحد، لكنه عاجز عن تفسير مصدر موهبته.
“كل ما أعرفه أن لدي القدرة على حفظ خرائط النجوم”، قالها لي حين قمت بزيارته هو وزوجته “إيلاين” في منزله الواقع في بقعة هادئة على أطراف قرية “هازلبروك”، حيث تنتهي “سيدني” وتبدأ السهول الأسترالية الشاسعة. “أنا لا أجيد أشياء أخرى بالضرورة” أضاف: “لا أتذكر الأسماء جيدًا”، “أو أين وضع أشياءه”، تقول “إيلاين” من المطبخ.
هزّ رأسه موافقًا ثانية وابتسم سائلاً إياي ما إذا كنت أود رؤية تليسكوبه. كانت مخيلتي صوّرت لي أن “إيفانز” يملك مرصدًا كاملاً بمنزله في حديقته الخلفية، نسخة مصغرة من مرصد “جبل ويلسون” أو “بالومار”، مزودًا بسقف نصف كروي متحرك ومقعد مزود بتحكم ميكانيكي لضبط وضعه أوتوماتيكيًا. في الواقع، قادني ليس للخارج وإنما إلى غرفة تخزين مزدحمة في المطبخ حيث يحتفظ بأوراقه وكتبه وحيث يرقد تليسكوبه – أسطوانة بيضاء في حجم وشكل سخان ماء منزلي، مزود بقاعدة خشبية متحركة. حين يريد أن يرصد، يحمل معداته على مرتين لشرفة صغيرة خارج المطبخ. ومن بين أعلى سقف منزله والنباتات التي تتدلى من عليه، لا يتاح لـ”إيفانز”أكثر من نظرة عبر ثقب للكون، ولكن يقول “إيفانز” إنها أكثر من كافية بالنسبة له. وهناك حينما تصفو السماء ويتوارى نور القمر، يجد “إيفانز” “السوبرنوفا”.
حين ننظر لأعلى نحو السماء فإننا نرى أقل القليل من الكون. من الأرض وبالعين المجردة يمكننا أن نرى حوالي ستة آلآف نجم فقط. وفقط حوالي ألفين من موضع واحد على الأرض. بالنظارات المقربة عدد النجوم التي يمكنك رؤيتها من موضع واحد يقفز إلى حوالي خمسين ألفًا، أما باستخدام تليسكوب صغير من عيار البوصتين يقفز العدد إلى ثلاثمائة ألف. باستخدام تليسكوب ست عشرة بوصة – كالذي يستخدمه “إيفانز” – تبدأ في رؤية ليس نجوما فحسب بل مجرات أيضًا. من شرفته يُقدّر “إيفانز” أنه يستطيع رؤية ما بين خمسين ومائة ألف مجرة. كل منها يحوي عشرات البلايين من النجوم. هذه طبعًا أعداد محترمة جدًا، ولكن حتى مع هذا العدد الهائل فإن “السوبرنوفا” بالغة الندرة. يمكن أن تظل النجوم تحترق لبليون كامل من الأعوام، ولكنها تموت مرة واحدة وسريعًا، وفقط القليل من النجوم المحتضرة ينفجر. معظمها ينخمد بهدوء كنيران معسكر في الفجر.
في مجرة تقليدية، تحوي مائة بليون نجم، فإن انفجار “سوبرنوفا” سيحدث في المتوسط كل مائتي أو ثلاثمائة عام. لذا فإن العثور على “السوبرنوفا” كان بمثابة الوقوف أعلى مبنى “الإمباير ستيت” (Empire State Building) ممسكًا بتليسكوب والبحث بين نوافذ مدينة “مانهاتين” (Manhattan) على أمل العثور على شخص يشعل شموع عيد ميلاده الحادي والعشرين.
لذا يمكننا تخيل كيف تصور مجتمع الفليكيين الظنون بعقل القس معسول الكلام الذي اتصل بهم أملاً في العثور على خرائط تساعده في البحث عن انفجارات “السوبرنوفا”. في ذلك الوقت كان “إيفانز” يملك تليسكوبًا بعشر بوصات – وهو مقياس محترم جدًا بالنسبة لراصد هاوٍ ولكنه لا يقترب أبدًا من المقياس اللازم عادة للانخراط في بحوث كونية جادة – وكان يقترح العثور على واحدة من أندر الظواهر الكونية. على مدى تاريخ الفلك قبل بدء “إيفانز” في بحوثه في عام 1980، كان عدد المرات التي شوهد فيها “سوبرنوفا” ستين مرة، “في وقت زيارتي له في أغسطس عام 2001 كان قد سجل للتو اكتشافه الرابع والثلاثين، تبعه الخامس والثلاثون بعدها بثلاثة أشهر، والسادس والثلاثون في بدايات عام 2003”.
لكن “إيفانز” كان يتمتع بميزات معينة. معظم الراصدين، كمعظم البشر عامة، يعيشون في نصف الأرض الشمالي، لذا فإن “إيفانز” كان يملك الكثير من السماء ليبحث فيه وحده، خاصة في البداية. أيضًا كان يملك السرعة وذاكرته غير العادية. التليسكوبات الكبيرة هي أجهزة معقدة، ومعظم أوقاتها التشغيلية تضيع في توجيهها وضبطها في الوضع المطلوب. “إيفانز” يستطيع أن يوجه تليسكوبه الست عشرة بوصة الصغير كبندقية، فلا يقضي أكثر من عدة ثوانٍ في أي موضع في السماء. نتيجة لذلك يستطيع أن يرصد ربما أربعمائة مجرة في الليلة، بينما يرصد مشغلو التليسكوبات الاحترافية الكبيرة خمسين أو ستين مجرة على الأكثر في حالة حالفهم الحظ.
البحث عن “السوبرنوفا” يعني في الغالب عدم العثور على أي منها. في الفترة ما بين عام 1980 وعام 1996 كان إيفانز يعثر على اكتشافين في العام الواحد في المتوسط. ليس عددًا كبيرًا إذا تذكرنا أنه تطلب مئات من الليالي المقضية في المراقبة والمزيد من المراقبة. في إحدى المرات وجد ثلاثًا في خمسة عشر يومًا، في وقت آخر قضى ثلاثة أعوام بدون أي اكتشافات على الإطلاق.
“في الواقع هناك فائدة لعدم العثور على أي شيء” يقول “إيفانز”. “يساعد هذا علماء الكونيات في حساب المعدل الذي تتطور به المجرات، في مثل هذه الحالة يكون عدم وجود أدلة هو دليل في حد ذاته، وهو شيء نادر الحدوث في العلم”.
على طاولة بجانب تليسكوبه يوجد أكوام من الصور والأوراق التي تتعلق ببحوثه، وقد أراني بعضًا منها، لا بد أنك في وقت ما نظرت في إحدى المنشورات الفلكية المعروفة. إنها عادة ما تمتلئ بصور أخاذة الألوان للسدم سحيقة البعد وما شابه، سحب ملونة ببهاء كوني أخّاذ يحرك أكثر المشاعر رقة. الصور التي يعمل بها “إيفانز” ليست كأي شيء من هذا. إنها مجرد صور بالأبيض والأسود بها نقاط مضيئة محاطة بهالات من الضوء المشوش. أراني واحدة تُظهر مجموعة من النجوم في وسطها شعلة ضئيلة كان لابد أن أقربها من وجهي لكي أراها. قال لي “إيفانز”: “هذا هو نجم في كوكبة تدعى “فورناكس” من مجرة يعرفها الفلك باسم مجرة ( (NGC1365″، (NGC) هي اختصار (New General Catalogue) أي الكتالوج العام الجديد، حيث تُسجل مثل هذه الأشياء. كان هذا الكتالوج يومًا ما كتابًا ثقيلاً على مكتب أحدهم في “دبلن” (Dublin)، اليوم هو بالطبع قاعدة بيانات”. لقد سافر الضوء الناتج من النهاية المروعة – لحياة هذا النجم – في الفضاء في صمت لستين مليون عام بلا انقطاع، حتى وصل في إحدى ليالي أغسطس من عام 2001 إلى الأرض في شكل نفحة من الضياء، لنراها كلمعان ضئيل في سماء الليل. لقد كان “روبرت إيفانز” بالطبع على ربوته – التي تفوح بروائح ورود اليوكاليبتاس – هو من لمحها.
يقول “إيفانز”: “يوجد شيء يرضيني في فكرة أن يسافر الضوء لملايين السنين خلال الفضاء، وبالضبط في اللحظة التي يصل فيها للأرض ينظر أحدهم في البقعة الصحيحة في السماء ليراه. إني أشعر أن حدثًا بمثل هذه الأهمية يجب أن يشاهده أحد”.
في عام 1987 وجد “سول بيرلماتر” (Saul Perlmutter) بمعمل “لورانس بيركلي” في “كاليفورنيا”، أنه بحاجة لعدد أكبر من “السوبرنوفا” من النوع (Ia) من ذلك المتوفر بالبحث البصري، فأخذ يعمل لإيجاد وسيلة أكثر نظامية للبحث عنهم. صنع “بيرلماتر” نظامًا باستخدام الحواسيب المتطورة وأجهزة تعرف بأجهزة الـ (Charge Coupled Devices)، وهي في الأساس كاميرات رقمية جيدة جدا. لقد أدى هذا لظهور أجهزة للبحث عن “السوبرنوفا” بشكل آلي. تستطيع التليسكوبات الآن أخذ آلاف الصور وتترك للحاسوب مهمة البحث عن العلامات الدالة على انفجارات “السوبرنوفا” في شكل نقاط مضيئة. في خمس سنوات تمكن “بيرلماتر” وزملاؤه بجامعة “بيركلي” من العثور على اثنين وأربعين “سوبرنوفا”، الآن حتى الهواة يعثرون على “السوبرنوفا” باستخدام هذه الأجهزة. “باستخدام مثل هذه الأجهزة يمكنك توجيه التليسكوب نحو السماء وتذهب لتشاهد التلفاز”، قالها “إيفانز” بلمحة عدم رضا. واستطرد قائلاً: “لقد أخرج هذا الرومانسية من الموضوع”.
سألته ما إذا كان قد شعر بإغراء تبني النظام الجديد في بحوثه. “أوه، لا” قال “إني أستمتع بطريقتي كثيرًا. بالإضافة” قال مشيرًا لإحدى صور أحدث اكتشافاته مبتسمًا “لا زال بإمكاني أن أسبقهم أحيانًا”.
السؤال الذي يطرح نفسه هو “ماذا ستكون نتائج انفجار نجم بالقرب منا؟” أقرب جيراننا الكونيون، كما رأينا هو “ألفا قنطورس” (Alpha Centauri)، والذي يبعد عنا 4.3 سنة
ضوئية. كنت أتصور أنه في حالة حدوث انفجار هناك سيكون أمامنا 4.3 أعوام لكي نشاهد الحدث المدهش ينتشر عبر السماء، كما لو أنه ينسكب من علبة عملاقة. ماذا سيكون شعورنا لو كان أمامنا أربعة أعوام وأربعة شهور لنشاهد دمارًا لا مهرب منه يتقدم نحونا، عالمين أنه حين يصل إلينا أخيرًا فإنه سيسلخ جلودنا تاركًا عظامنا نظيفة تمامًا؟ هل سيذهب الناس لأعمالهم؟ هل سيزرع المزارعون الزروع؟ هل سيوصلها أحدهم للباعة؟
بعدها بأسابيع في مدينة “نيو هامبشاير” حيث أعيش وجهت هذه الأسئلة لـ “جون ثورستينسون” الفلكي بجامعة “دارتموث”. “أوه لا” قال ضاحكًا “خبر مثل هذا الحدث يسافر بسرعة الضوء، ولكن كذلك الدمار نفسه، لذا فإنك ستعرف بوجوده وتموت به في نفس اللحظة. لكن لا تقلق لأن هذا لن يحدث”.
لكي يقتلك انفجار “سوبرنوفا”، أوضح لي “ثورنستون”، يجب أن تكون قريبًا بشكل لا يصدق من النجم المنفجر، غالبًا في نطاق عشر سنوات ضوئية تقريبًا. “الخطر سيكون ناتجًا عن أنواع متعددة من الإشعاع، منها الأشعة الكونية ونوعيات مشابهة من الإشعاع”، هذه الإشعاعات ستنتج هالات رائعة، شلالات متراقصة من الأضواء الأخّاذة تملأ السماء بأكملها. هذا لن يكون خبرًا سعيدًا بالنسبة لنا. أي حدث قوي بصورة كافية لإحداث مظاهر كتلك، يمكنه ببساطة أن يطيح بطبقة “الماجنيتوسفير” (Magnetosphere)، وهي الطبقة المغناطيسية، والتي تقع أعلى سطح الأرض، المسؤولة عن حمايتنا من الأشعة فوق البنفسجية والهجومات الكونية الأخرى. بدون هذه الطبقة أي شخص سيء الحظ سيخطو تحت أشعة الشمس سريعًا ما سيكتسب مظهر فطيرة بيتزا نُسيت في الفرن لفترة أطول من اللازم.
“السبب من تأكدنا أن شيئًا كهذا لا يمكن أن يحدث واقعيًا في ركننا المنزوي من المجرة” يقول ثورنستون، “أن الأمر يتطلب نوعًا خاصًا من النجوم لصنع “السوبرنوفا”. النجم المرشح يجب أن يتمتع بحجم من عشرة لعشرين ضعفًا من حجم شمسنا، و”نحن ليس لدينا أي نجوم بالحجم المطلوب في نطاقنا. لحسن حظنا فإن الكون مكان رحب. أقرب نجم يصلح لهذا الأمر” أضاف ثورنستون، “هو “بيتلجوس” (Betelgeuse) والذي أوحت انبعاثاته المتنوعة أن شيئًا ما غير مستقر بشكل مثير يحدث هناك. لكن “بيتلجوس” (بيت الجوزاء) يبعد عنا خمسين ألفًا من الأعوام الضوئية”.
إن حدوث “سوبرنوفا” بشكل قريب بما يكفي ليكون مرئيًا بالعين المجردة هو أمر نادر، فقد حدث ست مرات فقط في تاريخنا المدون. أحدها كان انفجارًا في عام 1054، والذي أنتج “سديم السرطان” (Crab Nebula). وانفجارًا آخر في عام 1604، صنع نجمًا شديد اللمعان لدرجة أنه ظل مرئيًا خلال النهار لأكثر من ثلاثة أسابيع. الأقرب كان في عام 1987، عندما أضاء انفجار “سوبرنوفا” في مكان من الكون يُعرف بالسحابة الماجلانية الكبيرة (large Magellanic Cloud)، وقد كاد أن يكون غير مرئي، ولم يكن بالإمكان رؤيته إلا من النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وكان يبعد عنا بمائة وتسع وستين ألفًا من الأعوام الضوئية.
“السوبرنوفا” مهمة لنا بشكل شخصي، فبدونها لم نكن لنكون هنا. هل تذكرالمعضلة الكونية التي طرحناها في نهاية الفصل الأول، وهي أن الانفجار الأعظم أنتج الكثير من الغازات الخفيفة ولكنه لم ينتج أي عناصر ثقيلة؟ فقد نتجت هذه العناصر لاحقًا، لكن لوقت طويل جدًا لم يستطع أحد أن يدرك كيف أُنتجت هذه العناصر. المشكلة كانت أنك تحتاج لمكان ساخن جدًا – أسخن من قلب أسخن النجوم – لكي تخلق الكربون والحديد والعناصر الأخرى، والتي بدونها لن يكون لنا أي وجود مادي. “السوبرنوفا” وفرت التفسير، ولقد اكتشف الحل عالم كونيات إنجليزي يقارب “فريتز زويكي” غرابة.
لقد كان رجلاً من “يوركشاير” يُدعى “فريد هويل” (Fred Hoyle). “هويل”، والذي تُوفي في 2001، وُصف في نعيه في مجلة الطبيعة (Nature) على أنه “عالم كونيات ورجل مثير للجدل”، ولقد كان يتمتع حقًا بكلتا هاتين الصفتين. لقد كان طبقًا لنعي مجلة “الطبيعة” “مغموسًا في الجدل طوال حياته” و”رُبط اسمه بالكثير من الهراء”. لقد ادّعى، كمثال، وبدون دليل أن حفرية “الأركايوبتركس” والتي تُعد إحدى كنوز متحف “التاريخ الطبيعي الإنجليزي” زائفة على غرار “خدعة بيلتداون” (Peltdown Hoax)، مما سبب الكثير من الغيظ لعلماء الحفريات العاملين بالمتحف، والذين تعين عليهم أن يقضوا أيامًا يتحاشون مكالمات من الصحفيين من جميع أنحاء العالم. لقد آمن أيضًا بأن الأرض لم تأتِ لها الحياة من الفضاء الخارجي فقط، بل وأيضًا أتى لها من الفضاء العديد من الأمراض، مثل “الإنفلونزا” و”الطاعون الدملي”، واقترح في وقت ما أن البشر تطوروا بأنوف ذات فتحات مواجهة لأسفل كطريقة لمنع العدوى الكونية من السقوط داخلهم.
إنه كان هو من صاغ مصطلح “الانفجار العظيم” (Big Bang) في لحظة سخرية، خلال برنامج إذاعي في 1952. لقد أشار إلى أن لا شيء مما نعرفه عن الفيزياء يفسر لنا كيف أن جمع كل مكونات الكون في نقطة واحدة سيجعلها تبدأ فجأة في التمدد. “هويل” كان يفضل نظرية الحالة الثابتة، والتي فيها يتمدد الكون باستمرار ويخلق مادة جديدة أثناء تمدده. أدرك “هويل” أيضًا أن انفجار نجم سيولد كميات هائة من الحرارة – مائة مليون درجة أو أكثر – كمًا كافيًا لبدأ تخليق العناصر الأثقل في عملية تُعرف “بالتخليق النووي” (Nucleosynthesis). وفي عام 1957، بيّن “هويل” بالتعاون مع آخرين كيف تتخلق العناصر الأثقل في انفجارات “السوبرنوفا”. تقديرًا لهذا العمل حصل (W. A. Fowler) على جائزة نوبل؛ على الرغم من أن “هويل” نفسه – ويا للعار- لم يحصل على جائزة مماثلة.
طبقًا لنظرية “هويل”، فإن النجم المتفجر سيولد كمًا كافيًا من الحرارة لكي يخلق كل العناصر الجديدة وينثرهم في أنحاء الكون، حيث سيتجمعون في سحب غازية تُسمى الوسط الكوني. هذه السحب ستتجمع في النهاية في شكل مجموعات شمسية جديدة. بهذه النظرية الجديدة تمكننا أخيرًا من بناء سيناريوهات معقولة لكيف جئنا هنا. ما نعتقد أننا نعرفه الآن هو الآتي:
منذ حوالي 4.6 بليون عام، بدأت سحابة من الغاز والغبار يبلغ عرضها 15 بليون ميل في التجمع في الفضاء حيث نوجد نحن الآن. تقريبًا كلها – 99.9٪ من كتلة المجموعة الشمسية – ذهبت لتصنع الشمس. من المادة العائمة الباقية، حبتان “ميكروسكوبيتان” اقتربتا معًا بشكل كافٍ لكي يلتصقا بفعل القوى “الإليكتروستاتيكية”. هذه كانت لحظة الحمل التي ستؤدي في النهاية لولادة كوكبنا. في جميع أنحاء المجموعة الشمسية البدائية تلك كان هذا يحدث مرارًا. ذرات التراب المتصادمة كوّنت كتلاً أكبر وأكبر. أثناء اصطدامها وارتطامها، أخذت هذه الكتل في التكسر والتجمع في تشكيلات عشوائية لانهائية، لكن في كل مقابلة كان هناك فائز، وبعض هؤلاء الناجحين نموا بشكل كافٍ لكي يستحوذوا على المدارات التي يقطعونها حول الشمس.
لقد حدث هذا سريعًا. لقد نما كوكبنا من مجموعة حبيبات إلى كوكب طفل يبلغ قطره مئات من الأميال في بضعة عشرات من الألوف من الأعوام. لقد تكوّنت الأرض كاملة في حوالي 200 مليون عام، لكنها مازالت سائلة ومائعة وتتعرض باستمرار للرجم من الحطام المحيط بها.
عند هذه النقطة، منذ حوالي 4.5 بليون عام، فإن جسمًا بحجم المريخ اصطدم بالأرض، مطيحًا بكمّ كافٍ من مادة الأرض لكي يكون كرة مصاحبة لها تُدعى القمر. خلال أسابيع، كما يُعتقد، كانت المادة المقذوفة قد جمعت نفسها في شكل كتلة واحدة، وخلال عام كانت قد تحولت للصخرة الكروية التي تصاحبنا حتى الآن. معظم مادة القمر كما يُعتقد جاءت من قشرة الأرض وليس قلبها، ولهذا فإن القمر يملك القليل من الحديد، بينما نملك نحن الكثير منه. تُقدم هذه النظرية دائمًا على أنها نظرية حديثة، لكن الحقيقة أن “ريجينالد ديلي” (Reginald Daly) اقترحها في الأربعينات. الجديد في الأمر هو أن الناس بدأت تهتم بها.
حينما كانت الأرض حوالي ثلث حجمها النهائي، كانت قد بدأت بالفعل في تكوين غلاف جوي، معظمه من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والميثان والكبريت. إنه خليط من الصعب أن يُكوّن مادة تدعم نشوء الحياة، ومع هذا فلقد تكوّنت الحياة من هذا الحساء السام. ثاني أكسيد الكرون غاز مدفأة زجاجية قوي. هذا كان شيئًا جيدًا لأنه حينها كانت الشمس أقل سطوعًا. لو لم نتمتع بفوائد تأثير المدفأة الزجاجية، لربما تجمدت بصفة نهائية، وربما لم تكن الحياة لتجد لنفسها موضع قدم. لكن بشكل ما بدأت الحياة.
لـ 500 مليون سنة التالية؛ الأرض كانت تُرجم باستمرار بالمذنبات، والنيازك والتي جلبت الماء لكي تملأ المحيطات والمكونات اللازمة لتخلق الحياة. لقد كانت بيئة معادية بشكل لا يصدق، ومع هذا بدأت الحياة. مجرد حقيبة بالغة الصغر من الكيماويات ارتعشت وصارت حية. ومن هنا نضع أقدامنا على أول الطريق.
بعدها بأربعة بلايين عام بدأ البشر في التساؤل عن كيفية حدوث هذا. وإلى هناك تأخذنا قصتنا.
بهذا ينتهي الفصل الثالث، وهو آخر فصول الجزء الأول، وسأبدأ قريبًا في الجزء الثاني “حجم الأرض”.